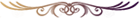
نص المنشور:
«مفهوم العبادة.
الكثير من المسلمين يلتبس عليه مفهوم العبادة، ويظن أنها الواجبات الدينية من صلاة وصوم وزكاه وحج... الخ، والواقع أنها ليست كذلك.
العبادة هي «الدعاء» بنصوص القرآن الكريم، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾، أي ليدعوني ويطلبوني فأستجيب لهم ويتبع ذلك موضحًا معنى «ليعبدون»: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾، ويقول تبارك وتعالى في موضع آخر: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ والآية واضحة في تحديد مفهوم العبادة «بالدعاء» وفي موضع آخر يخاطب نبيه منوِّهًا.. بـ «عباده» ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ إذن ما الواجبات الدينية ولماذا فرضت؟!!
الواجبات الدينية هي مجموعة من الشعائر فرضت بغرض تزكية النفس وتهذيبها، وتهيئتها لتلقي قبس من نور الله، فالصلاة فرضت للذكر والتقوى، يقول الحق تبارك وتعالى مخاطبًا موسى: ﴿فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، والآية واضحة في التفريق بين العبادة والصلاة، وتحديد العلة من الصلاة «لذكري»، وفي آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى مبينًا أهمية الصلاة في تهذيب وتزكية النفس ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾. ويقول سبحانه في علة فرض الصيام: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، والعلة واضحة «لعلكم تتقون». وفي الزكاة يقول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ إذن العلة هي الطهارة وتزكية النفس من الشح: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ويبيِّن في آية أخرى غناه سبحانه وتعاليه! بقوله: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾. إذن نخلص من كلَّ ذلك إلى أنَّ مدار ومناط ومحط الشعائر هي نفس الإنسان فعليها فرضت، ولها مردودها من تزكية وتهذيب وتدرج في مدارج السالكين الى الله، والله غني عنها فهو الغني سبحانه».
التعليق:
ابتداءً نقول: في هذا المنشور تقريرٌ للتفسير النفعي للدين بطريقةٍ ملتويةٍ فيها قدْرٌ من التحريف والتخليط، ونسفٌ للحقائق الثابتة عند الأمة صغيرها وكبيرها، بل وحتى عند الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لا لشيء إلا لتمرير التفسير النفعي بحجة التحقيق وكشف اللبس فيما زعم كاتبه، والحقيقة أنه هو من لبَّس على الناس بهذا المقال دون سبب وجيه، بل كان يستطيع أن يقرر ما يريد من دون ارتكاب هذه الشناعات بتحريف معاني الآيات وخرق الاجماع، وإن كان تقرير التفسير النفعي بحدِّ ذاته شنيعًا لكن أن يأتي أحدٌ فيحرف المقصود بالعبادة والعبادات ويقرر أن الدعاء هو العبادة دون غيره من أركان الإسلام فهذا جُرم كبير يحتاج لوقفات فنقول:
أولًا: ما قرره صاحب المنشور من معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ـ وأن المراد بالعبادة هو الدعاء دون أركان الإسلام التي يحصرها في تسمية «شعائر»، وتعليله بأن الله ذكر غناه عن الطعام والرزق ـ قول باطل لم يبيِّن كاتبه وجه الدلالة عليه في الآية، هذا فضلًا عن مخالفته لتفسير السلف والخلف، فهذا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري يقول في تفسير آية سورة الذاريات: «ما خلقتُ الجنَّ والإنس إلا لعبادتنا، والتذلل لأمرنا» [تفسير الطبري 21/ 555]
وقال ابن الجوزي مستعرضًا أقول المفسرين: «واختلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: إلا لآمرهم أن يعبدوني. والثاني: إلا ليقروا بالعبودية طوعًا وكرهًا. والثالث: أنه خاص في حق المؤمنين. والرابع: إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا» [زاد المسير 4/ 173]
وفصَّل شيخ الإسلام في هذه الأقوال تفصيلًا بديعًا يرجع إليه في «مجموع الفتاوى» 8/ 39 وقد زاد على الأقوال السابقة قولين آخرين ثم قال رحمه الله:
«القول السادس ـ وإن كان أبو الفرج لم يذكر فيها إلا أربعة أقوال ـ وهو الذي عليه جمهور المسلمين أن الله خلقهم لعبادته، وهو: فعلُ ما أمروا به، ولهذا يوجد المسلمون قديمًا وحديثًا يحتجون بهذه الآية على هذا المعنى حتى في وعظهم وتذكيرهم وحكاياتهم ...وهذا هو المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ وغيره من السلف فذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم إلى عبادتي. قالوا: ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾ [البينة: 5] وقوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [التوبة: 31] وهذا اختيار الزجاج وغيره. وهذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت؛ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو أسامة، عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ لآمرهم وأنهاهم، كذلك روي عن الربيع بن أنس قال: ما خلقتهما إلا للعبادة» [مجموع الفتاوى 8/ 51]
وقال في موطن آخر: «وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ هذه الإرادة الدينية الشرعية، وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع، والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة فهو العمل الذي خلق العباد له: أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون مرضيين محبوبين فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادما لما يحب ويرضى ويراد له الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته وعادما لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه» [مجموع الفتاوى 8/ 189]
فأنت ترى أنه لا يوجد من استدلَّ بالآية على قصر معنى العبادة في الدعاء فقط.
ثانيا: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60] ليس فيها إلا تقرير أن الدعاء من العبادة وهو من أعظمها، وهذا لا خلاف فيه، ولا ينفي أن يكون غير الدعاء من العبادة، وهذا يوضحه:
ثالثًا: أن كاتب هذا المنشور جهل أو تجاهل المستفيض المشهور في تقسيم الدعاء إلى نوعين «دعاء مسألة ودعاء عبادة»، وأركان الإسلام الأربعة، وجميع العبادات الأخرى من نوع دعاء العبادة، فليس هناك تعارض بين دعاء المسألة ـ الذي جعله الكاتب وحده هو العبادة ـ وبين دعاء العبادة المتمثل بالعبادات على أنواعها، لأن كلا النوعين فيه مقصود الدعاء، وهو السبب الداعي للمسلم للقيام به، وهو ما يرجوه من الثواب والأجر والجزاء في الآخرة، فسواء طلب ذلك من الله بالمسألة المباشرة أو تعبد لله بالشعائر قاصدًا هذا الأمر فهو في الحالتين داعٍ لله سائلٍ منه، وكلا النوعين متلازمان.
ومما يدل على جهل الكاتب أنك لا تكاد تجد كتابًا في العقيدة الصحيحة من شروح كتاب التوحيد وغيرها يغفل ذكر هذه المسألة فهي أشهر من أن تذكر ويدلل عليها:
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «قول الله عز وجل: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)﴾ [الأعراف]: هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة، ودعاء المسألة؛ فإنَّ الدعاء في القرآن يُراد به هذا تارة، وهذا تارة، ويراد به مجموعهما؛ وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره ودفعه. وكلّ من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بدَّ أن يكون مالكًا للنفع والضر. ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرًّا ولا نفعًا. وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ [يونس: 106] وقال: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [يونس: 18] فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضرّ والنفع القاصر والمتعدي، فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر، فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفًا ورجاءً دعاء العبادة فعلم أن النوعين متلازمان فكلّ دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. وكلّ دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وعلى هذا فقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: 186] يتناول نوعي الدعاء. وبكلٍّ منهما فسرت الآية». [مجموع الفتاوى 15/ 10]
وعليه: فلا تعارض أصلًا بين دعاء المسألة ودعاء العبادة الذي هو أركان الإسلام وغيرها، لأنهما متلازمان ولا مسوِّغ لهذا التفسير الغريب، ولكن من يروم تحريف الدين وتوجيه أنظار وعقائد المسلمين لغاياتٍ نفعيةٍ يبدأ بمثل هذه التحريفات، فيشكك الناس بالثوابت آخذًا بما يظنه قد فهمه من القرآن ضاربًا عرض الحائط كل الأدلة والبراهين على خطأ زعمه وفهمه، فينتج عن ذلك تفريغ العبادات من معانيها الأصلية ليضفي إليها معانٍ نفعية بحجة تطهير النفس ونفع الانسان فقط
رابعًا: في هذا المنشور خرق لاتفاق أهل اللغة على تعريف التعبد والعبادة وتفسيره بالذل والخضوع مع الحب والتعظيم، وليس هذا مختصًا بالدعاء فقط دون أركان الإسلام الأخرى من الصلاة والصيام والزكاة والحج فكلها أنواع ومظاهر للتعبد لله مقصودة لذاتها. قال ابن جرير الطبري رحمه الله مبيِّنًا معنى العبودية عند جميع العرب: «العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة، وأنها تسمي الطريق المذلل الذي قد وطئته الأقدام وذللته السابلة: معبدًا. ومن ذلك قول طرفة بن العبد:
تباري عتاقًا ناجيات وأتبعت … وظيفًا وظيفًا فوق مور معبد
يعني بالمور: الطريق، وبالمعبد: المذلل الموطوء، ومن ذلك قيل للبعير المذلل بالركوب في الحوائج: معبَّد، ومنه سمي العبد عبدًا لذلته لمولاه. والشواهد من أشعار العرب وكلامها على ذلك أكثر من أن تحصى». [تفسير الطبري 1/ 159].
وقال ابن الجوزي رحمه الله: «ومعنى العبادة في اللغة: الذل والانقياد». [زاد المسير 4/ 173]
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «والعبادة أصل معناها الذلّ أيضًا يقال: طريق معبَّد إذا كان مذلَّلًا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذلّ ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له» [العبودية 48]
وبهذا يتبين كيف أن هذا المنشور قصر التعبد على الدعاء وفرَّغَ أركان الإسلام «الشعائر» عن معاني التعبد والتذلل والحب والتعظيم بجعلها وسائل فقط، وهي التي لا تقبل أصالةً ولا تعد عبادة إلا بهذه النية والمقصد، فالتعبد الذي هو التذلل والخضوع والمحبة لله شرط في اعتبارها عبادات وهذا المعنى شامل لها وللدعاء فلا تنافي بينهما. ومما يزيد الأمر وضوحًا:
خامسًا: قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] قد استدل به صاحب المنشور على المغايرة بين العبادة والصلاة، فالصلاة بحسب تقريره ليست عبادة لأن الواو قد غايرت بينها وبين العبادة، وقد أوتي من جهله، فكونه تعالى عقَّب بالواو بين شيئين لا يلزم منه المغايرة بينهما من كل وجه دائمًا، فكثير ما تأتي الواو من باب عطف الخاص على العام لإظهار مزيته والتنبيه على أهميته كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (٩٨)﴾ [البقرة: 98]، ومع هذا فدونك شيء من تفسير علماء التفسير في آية سورة «طه» السابقة:
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: «وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة إذ هي تضرع إلى الله تعالى، وقيام بين يديه، وعلى هذا فالصلاة هي الذكر. وقد سمى الله تعالى الصلاة ذكرًا في قوله: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾». [الجامع لأحكام القرآن 11/ 177]
وقال البيضاوي رحمه الله في تفسيره:
«﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ خصَّها بالذكر وأفردها بالأمر للعلة التي أناط بها إقامتها، وهو تذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره». [أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4/ 24]
وقال الشوكاني رحمه الله في تقرير بديع: «ثم أمره سبحانه بالعبادة فقال: «﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ خصَّ الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة، لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة، وعلَّل الأمر بإقامة الصلاة بقوله ﴿لذكري﴾، أي: لتذكرني فإن الذكر الكامل لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة». [فتح القدير 3/ 423] وعليه:
سادسًا: بمثل ما سبق يقال في الاستدلال على نفي العبادة عن الصيام والزكاة والحج، بحجة أنه تعالى ذكر ما يتعلق بها من أمور أخرى، والحقيقة أن هذه المتعلقات لا تنافي التعبد بل هي داخل فيه ولازمة من لوازمه، فالتقوى في الصيام والحج من لوازم التعبد لله، فلو لم يورث هذا التعبد التقوى فلن يكون تعبدًا كاملًا، وهذا بشمل الدعاء فضلًا عن غيره من العبادات، وقل مثل هذا في الطهارة والتزكية التي تظهر بشكل بارز في عبادة الزكاة.
سابعًا: ومما يقال كذلك ويجب التنبيه عليه: أن هذا الكلام الذي يجرد الشعائر وأركان الاسلام عن أن تكون عبادات ومن ثم حصر التعبد في الدعاء فقط، والتفصيل في علل الشعائر وما يعود منها إلى منفعة الانسان، يجعل العبادة لا علَّة فيها ولا حكمة من فرضها فلا فائدة تعود على الإنسان منها، وعليه فلا يلتفت لجميع المواضع التي تحثُّ وترغبُ في التعبد، وترهب من تركه، لأنها بزعم كاتب المنشور ليست هي الشعائر أركان الإسلام المعروفة، فكلها على ـ زعم كاتب المنشور ـ المراد بها الدعاء فقط، وهذا يدعونا أخيرًا للتنبيه على قضية خطيرة زلت فيها أقدام وطاحت بها أفهام وهي:
ثامنًا: أن التعبد لله بجميع العبادات ليس متعلقًا بالعبد فقط بل لها تعلق بالله عز وجلَّ من جهة أنه الرب المستحق للعبادة فهو يحب أن يُحمد وأن يُعبَد وأن يذكر ويشكر، ويرضَى بعبادته، ويأمر بها تعظيمًا لنفسه المقدَّسة.
إن كثيرًا ممن يجعل العبادة متعلقة بالعابد فقط ينفي أن يعود أو يتعلق شيءٌ من ذلك بالله، وذلك خوفًا منهم أن ينسبوا لله حاجة أو منفعة تعود إليه، وهو سبحانه الغني بنفسه عن كل ما سواه.
لا شك أن الله تعالى لا تنفعه طاعتنا، ولا تضره معصيتنا، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: 7]. والله تعالى ذكر الحج فقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)﴾ [آل عمران: 97]. لهذا فإن المنفعة والمضرة راجعة إلى الإنسان، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٤٦)﴾ [فصلت: 46]، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١٥)﴾ [الجاثية: 15].
لكن هذا لا يعني ولا يلزم منه أن العبادات لا تعلق لها بالله تعالى، لكن بعض أهل الضلال جعلوا هذا الأصل الصحيح ـ وهو غنى الله تعالى ـ مخلًا لقطع الصلة بين العباد وربِّهم، وزعموا أن العبادات بلا مقتضٍ ولا معنًى إلا منفعة الإنسان نفسَه، لهذا يفسرون العبادات تفسيرًا ماديًّا ونفعيًّا ومصلحيًّا. يقولون: أنت لا تصلي لله لأن الله غني عن صلاتنا بل تصلي لنفسك: فالصلاة قوة روحية، وتربية نفسية، ورياضة بدنية. والزكاة: اشتراكية وتكافل اجتماعي. والصيام: صحة نفسية وجسدية وتربية أخلاقية. والحج: مؤتمر سياسي. وهكذا يفسرون كل العبادات بأنها مقطوعة الصلة بالله، وأن الغاية منها الإنسان نفسه، وهذا انحراف خطير في فهم العبادة والغاية منها، وهو من عقائد أهل الفلسفة والكلام الذين يزعمون أن الله لا يُحِبُّ ولا يُحَبُّ، ولا يرضى ولا يغضب.
أما في الكتاب والسنة، فتعلق العبادات بالله تعالى واضح وصريح، فالله تعالى رب العالمين هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فهو المستحق لذاته للحب والتعظيم والخوف والذل والخضوع، هو المستحق أن يعبد: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٠٢)﴾ [الأنعام: 102]. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» [أخرجه البخاري ومسلم]. لهذا فإنَّ الله تعالى يحبُّ من يعبده ويوحده، ويرضى عنه، بل يفرح بتوبة التائبين كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.
ومحبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له ثابتة في كتاب الله كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾، وقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، وقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾. وكذلك رضا الله تعالى والرضا عنه، كما قال سبحانه: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾. وقال تعالى عن المؤمنين في سورة المجادلة: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٢)﴾. لهذا فإن من يكفر بالله ويعصي أوامره فإن الله يغضب عليه: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (٨١) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (٨٢)﴾. لهذا قال الله تعالى عن الذبح لله تعالى كالهدي والأضاحي: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (٣٧)﴾. ومعنى: ينال: أي يصل. فأخبر الله تعالى أن العبادات والأعمال الصالحة تصل إليه سبحانه.
قال ابن تيمية رحمه الله: «والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الذلِّ ونهايته وكمال الحبِّ لله ونهايته، فالحبّ الخلي عن ذلٍّ والذل الخلي عن حبٍّ لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد، والله غني عنها، فهي له من جهة محبته لها، ورضاه بها. ولهذا كان الله أشدَّ فرحًا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية ملهكة إذا نام آيسًا منها ثم استيقظ فوجدها فالله أشدّ فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته... وكون هذا لله وهذا للعبد هو اعتبار تعلق المحبة والرضاء ابتداءً، فإنَّ العبد ابتداءً يحب ويريد ما يراه ملائمًا له والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، وحبه الوسيلة تبعًا لذلك وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك يحبه الله ويرضاه» [التحفة العراقية 44]. وبالله تعالى التوفيق.