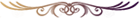
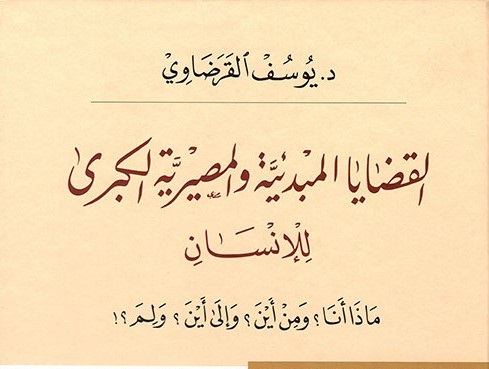
الحمد لله ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فقد وقفتُ على كتابٍ جديدٍ للشيخ الدكتور يوسف القرضاويِّ، عنوانُه: (القضايا المبدئية والمصيرية الكبرى للإنسان: ماذا أنا؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ ولِمَ؟)، نشر الدار الشامية، تركيا، الطبعة الأولى: 1438/2017، في مجلد لطيف، 224 صفحة، فلم أتردَّد في شرائه، لأنه داخلٌ في صُلب اهتمامي، ولمؤلفه شهرةٌ واسعةٌ، وكتابه هذا خلاصةُ حياته (90 عامًا) ومسيرته العلمية والفكرية والدعوية والثقافية والحركية الطويلة الواسعة، امتدَّتْ لأكثر من سبعة عقودٍ مليئةٍ بالنشاط والإنتاج، والخبرات والتجارب. ومن البديهيِّ أن لا تغيب هذه المعاني عن المؤلف وهو يسطِّر كتابه هذا، فنجده قد استفتحه بهذه الجملة: (مقدِّمة: هذا الكتاب أكتبه في أواخر حياتي،...)، وختم مقدمته بالاسم والتاريخ: (د. يوسف القرضاوي الدوحة 5 من جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 14 مارس 2016م)، فهذا الكتاب من تأليفه قطعًا، والأسلوب أسلوبه، بل فيه مباحث من كتبه ومقالاته القديمة، إلا أن مضمونَه بهذا الوضوح والتكامل والتركيز قد لا يتوقَّع أكثرُ القراء أن يكون للقرضاوي، لهذا وجدتني مضطرًا للبدء بهذا التوثيق ـ كأنني أُعرِّف بمخطوطةٍ نادرةٍ! ـ حتى لا يبادر أحدٌ إلى اتِّهامي بالتقوُّل على الشيخ والافتراء عليه!
ألَّف القرضاويُّ كتابَه هذا لتقرير قضيةٍ كليَّةٍ مركزيَّةٍ واحدةٍ، وهي: أنَّ القضية المبدئية والمصيرية الكبرى للإنسان هي الحياة الآخرة الأبدية، والغاية في هذه الحياة الدنيا تتمثل في العمل للفوز والنجاة في تلك الدار، وما ذلك إلا بعبادة الله تعالى والإخلاص له وابتغاء مرضاته، فالعبادة هي غاية الخلق، وشرط الفوز والنجاة. وتتجلى هذه القضية بأهميتها ومركزيتها وأولويتها من خلال بيان الحقائق التالية:
أولًا: أن العبادة هي غاية الخلق:
يقول القرضاويُّ تحت عنوان: (لماذا خلق الإنسان؟) ص 48: (سيردُّ الله على تساؤلنا بما بيَّن لنا في كتابه، كتاب الخلود: أنه خلقه ليكون خليفةً في الأرض؛ وهذا واضح في خلق آدم... وأول شيء في هذه الخلافة: أن يعرف الإنسانُ ربَّه حقَّ معرفته، ويعبده حقَّ عبادته، قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق: 12]؛ وفي هذه الآية جعلت معرفة الله هي الغاية من خلق السماوات والأرض. ويقول تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: 56-58]...)، إلى أن يقول 49: (والإنسان ـ إذن ـ بحكم الفطرة ومنطق الكون، إنما هو لله سبحانه لا لغيره، لعبادته وحده، لا لعبادة بشرٍ ولا حجَرٍ، ولا بقَرٍ ولا شجرٍ، ولا شمسٍ ولا قمرٍ، ولا لجنٍّ ولا مَلَكٍ، وكل عبادة لغير الله إنما هي من تزيين الشيطان عدوِّ الإنسان).
ويقول 121: (فإذا كان الأحمقُ يعيش ليأكلَ، والعاقلُ يأكل ليعيشَ، فإنَّ المؤمنَ يعيش ليعبد الله وحدَه. يقرِّرُ القرآن هذه الحقيقةَ بوضوح وجلاء، حين يذكر الغاية من خلق الجنِّ والإنس، فيقول تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}).
ويقول 127: (لقد اختصر الإسلامُ غايات الإنسان في غايةٍ واحدةٍ، هي إرضاء الله تعالى، وركز همومه في همٍّ واحدٍ، هو العمل على ما يرضيه سبحانه).
ثانيًا: تحقيق العبودية لله تعالى هو رسالة (الدِّين) ومهمته ووظيفته:
يقول القرضاويُّ في الفصل السابع من كتابه (ماذا يقدِّم الدينُ الصحيح للإنسان؟)، تحت عنوان: (الغاية الأولى للإنسان: الربانية: أن يعيش لله وحده) 119: (يصحِّحُ الدين للإنسان غايته، بدل أن يخبط في الحياة خبط عشواء، لا يعرف له غايةً ولا هدفًا، وبدل أن يعيش لشهواته وملذَّاته يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام؛ يأخذ الدينُ بيده إلى ربَّانية الغاية والوجهة، بالتعبد لله تعالى، وهذه الربانية تعني: أن يجعل الإنسانُ غايتَه الأخيرة، وهدفه البعيدَ هو حسن الصلة بالله تبارك وتعالى، والحصول على مرضاته، فهذه هي غاية الإسلام، ومن ثَمَّ؛ فهي غاية الإنسان، ووجهة الإنسان، ومنتهى أمله وسعيه، وكدحه في الحياة: {يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ} [الانشقاق: 6]، {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى} [النجم: 42]).
ثالثًا: تفسير التوحيد بإخلاص العبادة لله وحده:
يقول القرضاوي 120: (ومعنى التوحيد: أن يعلم الإنسان أنه لا إلهَ إلَّا الله، وأن يفرده تعالى بالعبادة والاستعانة، فلا يشركَ به أحدًا، ولا يشرك معه شيئًا. وهذا معنى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} التي يرددها المسلم في صلواته كل يوم، ما لا يقل عن سبع عشرة مرة، كلما قرأ فاتحة الكتاب في ركعة من ركعات الصلاة. ولقد خاطب الله تعالى رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة، وأمره أن يعلنها ويبلِّغها للناس، فقال: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ * قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: 161-164]).
رابعًا: النداء الأول في كل رسالةٍ: (اعبدوا الله ما لكم من أله غيره):
تحت هذا العنوان كتب القرضاويُّ 139: (هذه العبادة لله وحده، هي العهد القديم الذي أخذه الله تعالى على بني الإنسان، وسجَّله بقلم القدرة في فِطَرهم البشرية، وغرسه في طبائعهم الأصيلة، منذ وضع في رؤوسهم عقولًا تعي، وفي قلوبهم قلوبًا تخفِقُ، وفي الكون حولهم آياتٍ تهدي: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} [يس: 60-61]. هذا العهدُ بين الله وعباده هو الذي صورَّه القرآن في روعة وبلاغة حين قال: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ} [الأعراف: 172-173]. فلا عجبَ أن يكون المقصِدُ الأعظم من بعثة النبيين، وإرسال المرسلين، وإنزال الكتب المقدسة؛ هو تذكير الناس بهذا العهد القديم، وإزالة ما تراكم على معدن الفطرة من غبار الغفلة، أو الوثنية، أو التقليد، ولا عجب أن يكون نداء الرسل الأَوَّل لأقوامهم: {يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}. بهذا دعا قومه: نوحٌ، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وشُعيب، وكلُّ رسول بُعث إلى قوم مكذبين، قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36]، {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25]، وقال تعالى بعد أن ذكر قصص طائفة كبيرة من الأنبياء: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 92]، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} [المؤمنون: 51-52]).
وبالجملة فقد قرَّر القرضاويُّ أن (العبادة) هي غاية الخلق، ووظيفة الإنسان في هذه الحياة، وهي قضية الدين بيانًا وأمرًا وتشريعًا، ودعوة جميع الرسل عليهم السلام، وهي حقيقة التوحيد الذي يراد به وجه الله تعالى، والنجاة في الآخرة، فهذه هي قضيةُ (القضايا المبدئية والمصيرية الكبرى للإنسان).
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: لكن لقائلٍ أن يقول هاهنا: وما الجديد في هذا؛ فهذه الحقائق الكلية الكبرى من أظهر أصول الإسلام، وأجلَى أخباره، وأحكم أوامره، يعرفُها ويقرُّ بها كلُّ مسلمٍ لم يتلوَّث بعقائد الفلاسفة والباطنية والزنادقة، والإسلاميون الحركيُّون يقرون بها، ويقررونها في الجملة، لكن أكثرهم إذا جاؤوا إلى التفصيل قالوا: (إن العبادة المقصودة هي عمارة الأرض، وهي وسيلة غير مقصودة لذاتها، والغاية المقصودة إقامة العدل وسعادة البشرية، فالعمل للدنيا وفق منهج الله هي طريق النجاة في الآخرة)؟!
فأقول: لم يقف القرضاوي في تقريراته عند هذه المفاهيم الكلية، بل بيَّن بيانًا جليًّا، وفصَّل تفصيلًا وافيًا، يُعلم منهما: أن العبادة هي حقٌّ خالص لله تعالى، وهي الغاية المقصودة لذاتها للنجاة في الحياة الآخرة الأبدية، وليست وسيلة لعمارة الأرض وإقامة النظام الاجتماعي والسياسي، بل هذه الأخيرة وسيلة لخدمة غاية العبادة، فهو بهذا يخالف من سبقه من الإسلاميين الحركيين ـ مثل حسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب والمودودي وعلي شريعتي والخميني وغيرهم كثير ـ في اعتقادهم أن العبادة غير مقصودة لذاتها، بل هي وسيلة لإصلاح النفس والمجتمع وإقامة النظام الاجتماعي والسياسي، كما وثَّقتُه عنهم مفصَّلًا في كتابي: (مقدمة في تفسير الإسلام).
أما القرضاويُّ فقد قال ـ بعد بيانه أن العبادة هي الغاية المقصودة من الدين كلِّه ـ 119: (ولا جدال في أن للإسلام غاياتٍ وأهدافًا أخرى: إنسانية، واجتماعية، وثقافية، واقتصادية، وسياسية، ولكن عند التأمل نجد هذه الأهداف في الحقيقة خادمةً للهدف الأكبر، وهو مرضاة الله تعالى، وحسن مثوبته. فهذا هو هدف الأهداف، أو غاية الغايات، هو الغاية الأولى، والغاية القصوى). وهذا صريحٌ في أن الغايات الأخرى في الإسلام تأتي في مرتبة ثانوية من الغاية الأولى الكبرى: (العبادة).
ثم بيَّن هذا على وجه التفصيل فقال 120: (في الإسلام تشريع ومعاملات، ولكن المقصود منها هو تنظيم حياة الناس حتى يستريحوا، ويبرؤوا من الصراع على المتاع الأدنى، ويفرغوا لمعرفة الله تعالى، وعبادته، والسعي في مرضاته).
وهذا التقرير في غاية الأهمية، وهو من حقائق الإسلام الكبرى، وقد سبقه إلى بيانها كثير من العلماء كالفخر الرازي وأبي حامد الغزالي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، حيث بيَّنوا أن جميع أحكام الشريعة المتعلقة بتنظيم شؤون الفرد والمجتمع والدولة؛ إنما هي أحكام غائية مصلحية جاءت لخدمة الغاية الكبرى؛ وهي تفرغ العباد لما خلقوا له من عبادة ربهم.
ثم قال القرضاوي 120: (وفي الإسلام جهاد وقتال للأعداء، ولكن الغاية هي: {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39]. وفي الإسلام حثٌّ على المشي في مناكب الأرض، والأكل من طيباتها، ولكن الغاية هي شكر نعمة الله وأداء حقِّه: {كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} [سبأ: 15]. وكلُّ ما في الإسلام من تشريع وتوجيه وإرشاد؛ إنما يقصد إلى إعداد الإنسان ليكون عبدًا خالصًا لله، لا لأحد سواه، ولهذا كان روح الإسلام وجوهره هو التوحيد...) وذكر معنى التوحيد، وقد نقلناه آنفًا. فقوله: (وكلُّ ما في الإسلام من تشريعٍ وتوجيهٍ وإرشادٍ؛ إنَّما يقصد إلى إعداد الإنسان ليكون عبدًا خالصًا لله)؛ في غاية الوضوح والقطع بأن التشريعات وسائل لغاية العبادة، خلافًا لما يصرِّح به أكثر الإسلاميين الحركيين اليوم من أنَّ العبادة وسيلةٌ لإقامة التشريعات الاجتماعية والسياسية والنفعية الدنيوية.
الضَّرورة الشرعية والفطرية والعقلية تقضي ـ بعد هذا ـ أن تكون قضيةُ العبادة والعمل للآخرة ـ في اعتقاد جميع المسلمين ـ: أصلَ الأصول، وأهمَّ المهمات، وأولى الأولويات، فيكون لها محلُّ التقدم والصدارة في عنايتهم واهتمامهم علمًا وعملًا، ودعوةً وتبليغًا، ونصيحةً وإرشادًا، ورعايةً وإصلاحًا، وحراسةً ودفاعًا، وتكون العناية والاهتمام بجميع القضايا الأخرى بدرجةٍ ثانويةٍ، ومرتبةٍ فرعيَّةٍ، حتى ولو كانت متعلقة بالأحكام الشرعية العملية، فكيف إن كانت متعلقة بأمور الدنيا المحضة، وتفاصيلها الطارئة الزائلة؟!
أدرك الشيخُ القرضاويُّ هذه الضرورة الشرعية والفطرية والعقلية، والتزم بلوازمها، فعبَّر عن ذلك في مواضع من كتابه:
1- يتكلَّم القرضاويُّ عن بواعثه على تأليف كتابه هذا فيقول 10: (نحن نريد من الناس أن ينتبهوا لأنفسهم، وأن يأخذوا القضية مأخذ الجدِّ، وخصوصًا هؤلاء الناس الذين يعيشون آكلين شاربين، لابسين ساكنين، متمتعين بحياتهم القصيرة،...)، (هذه الأسئلة الخالدة التي حصرها الناس بقولهم: ماذا أنا؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ ولِمَ؟ هذه الأسئلة وأجوبتها هي ما حاولنا أن ننَبِّه عليها، ونَلفتَ الأنظارَ إليها، ونوقظ الإنسانيةَ كلَّها إلى الإجابة عليها، والإعداد لها؛ فالأمر خطيرٌ، وهو بالعناية جدير).
2- ويحدِّد ما يجب على الناس ـ كلِّ الناس ـ إزاء الغاية والمصير فيقول 6: (لا بدَّ للناس أن تؤرِّقَهم وتوقظهم وتُتْعِبَهم هذه القضية الكبرى، التي يبحث كل إنسان فيها عن هُوِيَّته، وعن موقعه في هذا الوجود، وخصوصًا بعد أن يُنقَضَ هذا الكيان القائم، وهو الكون، ويأتي كيان آخر: ماذا له فيه؟).
3- ويبثُّ القرضاوي مُرَّ الشكوى من انشغال الناس وغفلتهم 103: (ولكن مما يؤسف له: أنَّ الناس شغلهم اللَّهو عن الجدِّ، وألهاهم الباطل عن الحقِّ، وغرَّهم الشيطانُ عن الله تعالى ربِّهم الأعلى، الذي خلق فسوَّى، والذي قدَّر فهدى).
4- ويشير القرضاوي إلى حال أكثر الناس في انغماسهم في الاهتمام بالدنيا وقضايا التفصيلية 5: (لا بدَّ أن يُعمِل الإنسان عقلَه في هذه القضية الكبيرة، التي ينبغي أن تُقدَّم على كل القضايا السياسية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، التي يبحث فيها الناس ويتكلَّمون، ويُصْدِرون توصياتٍ وقراراتٍ، وقد لا يستطيعون أن يصلوا فيها إلى شيءٍ يُجمِع عليه الناسُ).
ويقول 9: (إن البشرية شَغَلتْ نفسها بأمور كثيرة، من أجل أوطانها، ومن أجل غيرهم، ومن أجل أمور العيش ومطالب الحياة، ومن أجل أمورٍ أخرى، بعضُها يتعلق بالسياسة، وبعضها يتعلق بالثقافة، وبعضها يتعلق بالهُويَّة. واختلف الناس فيما بينهم كثيرًا، وتحاربوا وتعادوا، وأحيانًا يتفقون، بفعل نزعات الخير في بعض بني الإنسان، واستجابة بعض القادة لها، ثم سرعان ما يغلب الشرُّ الخيرَ، وتعود المعركة كما كانت، ولا يزال الإنسان يعاني من هذه الويلات). أما القرضاوي فيخالفهم فيقول: (وكنَّا نتمنَّى أن تأخذ هذه القضايا الكبرى: القضية المصيرية الأولى، وقضية مبدأ الإنسان، ومبدأ العالم، ومبدأ الحياة، ونحوها من قضايا الإنسان الكبرى؛ حيزًا معقولًا، ومساحةً مناسِبةً من إنتاجات الثقافة العامة، ومن كتابات الأدباء والمفكرين والفلاسفة، ومن محاولات الإعلام الكبيرة التأثير في حياة الناس الشخصية والعامة، المادية والمعنوية.. ولكنَّا للأسف لم نجد في كثير من الإعلاميين الرغبةَ في الدخول إلى هذا المأزق الذي يعتبرونه خطيرًا).
5- وإذا كان السياسيون يهتمون بالدنيا حتى إنَّهم يعبرون عن مشكلة طارئة تتعلَّق بزمان معيَّنٍ ومكانٍ معيَّن بأنها: (المشكلة المصيرية) فما ذلك إلَّا غفلةً عن المشكلة الحقيقية الكبرى، وفي هذا يقول القرضاوي 11: (إنها (المشكلة المصيرية) التي يتحدَّث عنها بعض السياسيين في بعض الأقطار، وفي بعض الأحيان، ولكن الحقيقة: أن المشكلة المصيرية هي ـ حقًّا ـ مشكلةٌ عامةٌ، كل إنسان عنده هذه المشكلة، يلزم كل من كان في رأسه عقل يفكِّر، وكل من في قلبه ضمير يحسُّ: أن يبحثها، وأن يهتدي إلى حلِّها..).
6- وينبِّه القرضاويُّ إلى تقصير المسلمين في القيام بهذا الحقِّ الأكبر فيقول ـ عن واجب دعوة غير المسلمين ـ 136: (ولكن هل بلَّغَهم المسلمون؟ في ظنِّي أنَّ المسلمين مقصِّرون فيما عليهم، وعليهم أن يضاعفوا جهدهم، ويبذلوا أقصى ما يستطيعون، ليحصلوا على غايتهم، أو قليلًا منها، عسى أن يصلوا شيئًا فشيئًا إلى ما يريدون).
7- ويعبِّرُ القرضاوي عن خطاب أهل الدين والإيمان وهم يدعون الغافلين عن قضية الحياة الكبرى 21: (يا قومنا، نحن ندعوكم إلى أمرٍ خطيرٍ، ندعوكم إلى قضية المصير، بل لا توجد قضيةُ مصيرٍ حقًّا إلا هذه القضية التي ندعوكم لها، كل القضايا الكبيرة، أو ما يسميه الناس: الكبرى، من قضايا الدنيا، كلُّها قضايا زائلة، تبدأ اليوم، وتنتهي غدًا، أو بعد غدٍ، أو بعد أيام أو سنين. ولكن القضية التي لا تنتهي أبدًا، هي قضيتنا، قضية الخلود والدوام الأبدي).
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: لا عجب في أن يهتدي القرضاويُّ إلى إدراك هذه (الحقيقة المصيرية الكبرى) على الوجه الصحيح الموافق لدين الأنبياء والرسل ـ عليهم السلام ـ وأتباعهم إلى يوم الدين، وتقريره لأهميتها ومركزيتها وأولويتها، فإنها أصل أصول الإسلام، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، وإن ضلَّ عنها الفلاسفة والباطنية والزنادقة، وانحرف فيها أكثر الإسلاميين الحركيين في هذا العصر انحرافًا خطيرًا ـ وإن لم يبلغوا في ضلالهم إلحاد الفلاسفة ـ.
نعم؛ لا عجب في كلِّ هذا، إنما العجبُ كلُّه أن يكون القرضاويُّ قد انفصم في حياته العملية والدعوية والحركية عن هذه (القضية المصيرية الكبرى) انفصامًا خطيرًا، وابتعد عنها ابتعادًا تامًّا، فلا تكاد تجد أثر ما بيَّنه وقرَّره وشرحه في كتابه هذا في واقع عمله ودعوته، وفي عامة اهتماماته وأولوياته، ولا في تلاميذه وأصحابه والمتأثرين بدعوته وفكره. فمن حقِّنا أن نتوجَّه الآن إلى الشيخ الدكتور يوسف القرضاويِّ بهذا الخطاب، فنقول:
أيها الشيخ القرضاويُّ ـ وفقك الله للحق والهدى ـ إن كان ما كتبته في كتابك هذا توبةً حادثةً، وأوبةً صادقةً؛ فأعلنها، واصدع بها، قبل أن يأتيك اليقين، فقمِنٌ أن تُقبل توبتك، وتبرأَ ذمتك بين يدي الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 159-160].
وإن كانت هذه (الحقيقة المصيرية الكبرى) واضحة في عقلك، راسخة في قلبك، خلال مسيرتك العلمية والدعوية التي امتدَّت عقودًا طويلةً؛ فما الذي صرفَك وشغلك عنها؟ وحال بينك وبين أن تجعلها قضيتك الأولى والكبرى في جميع منابر العلم والدعوة والإعلام التي رقيتها، وما أكثرها؟!
ما الذي حملك ـ وأنت مدركٌ هذا الإدراك الحقَّ لغاية الخلق ووظيفة الإنسان في الحياة وقضيته المصيرية الكبرى ـ على الانشغال بما هو دونها بمراحلَ كثيرةٍ في الغاية والأهمية والأثر والعاقبة؟!
تعيب على (الإعلاميين) عدم رغبتهم (في الدخول إلى هذا المأزق الذي يعتبرونه خطيرًا)؛ فما الذي صدَّك عن القيام بهذه المهمة وقد هيَّأ الله تعالى لك منبرًا من أكبر المنابر الإعلامية في هذا العصر (قناة الجزيرة)، فشاركتَ في برنامج (الشريعة والحياة) في أكثر من (600) حلقة؛ فلا أعلم أنك خصصتَ حلقةً واحدةً لبيان (القضايا المبدئية والمصيرية الكبرى)، وإذا كنتَ تناولتَ في بعض الحلقات بعض العبادات الأصلية بمناسبة رمضان أو الحج؛ فإن مدار أكثر الحلقات كانت حول دنيا الناس ومشاكلهم الجزئية التفصيلية العاجلة التي يصدقُ فيها ـ حقًّا ـ قولُكَ: (ما يسميه الناس: الكبرى، من قضايا الدنيا، كلُّها قضايا زائلة، تبدأ اليوم، وتنتهي غدًا، أو بعد غدٍ، أو بعد أيام أو سنين. ولكن القضية التي لا تنتهي أبدًا، هي قضيتنا، قضية الخلود والدوام الأبدي).
ما الذي حملكَ ـ وأنت مدركٌ هذا الإدراكَ الحقَّ ـ على الانغماس في شؤون السياسة والحكومات والدول والأموال والأعمال، حتى غلب ذلك عليك ـ خاصةً في ظهورك الإعلامي ـ لسنوات طويلة؛ فلما جاءتْ فتنةُ الخراب العربي ـ التي سميت زورًا بالربيع العربي ـ كنتَ من أشدِّ المؤيدين والمحرضين والداعمين لها، حتى تفاخرتَ على منبر الجمعة بوصف الناس لك بـ: (خطيب الفتنة)، وقلتَ: (ولن أتنازل عن خطبة الفتنة هذه، اللهم أحيني من خطباء الفتنة، وأمتني منهم، واحشرني معهم)! هكذا دعوتَ على نفسك؛ ولعلها كانت دعوةً في ساعةِ إجابةٍ!
أَلَم تعلم أنَّ تلك (الفتنة) شغلت الناس عن (قضيتهم المصيرية الكبرى)، ودفعتهم إلى الصراع على الدنيا، والانشغال بها عمَّا خُلقوا له، لهذا جاءت الأحاديث المتواترة في النهي عن الخوض في الفتن، ووجوب مجانبتها، والفرار منها، والانشغال بالعبادة التي هي غاية وجودهم؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العبادة في الهَرْج كهجرة إليَّ»؟!
وقد أمدَّ الله تعالى لك في العمر حتى رأيت نتيجةَ تلك الثورات؛ فاسأل نفسَك الآن: هل صار المسلمون بعدها أقربَ إلى الله تعالى؟ وأحرصَ على العمل للآخرة؟ وأسلمَ من المعاصي والموبقات؟ أم سقط كثيرٌ منهم في كبائر الذنوب؛ مثل القتل والظلم والبغي والكذب والفجور؟!
إذا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابيٍّ جليلٍ ـ قتلَ رجلًا قال: (لا إله إلا الله)، وكان في الأصل مشركًا حربيًّا، لا عصمة لدمه: «أقتَلْتَه بعدَما قال: لا إله إلا الله؟!»، وقال: «فكيف تصنَعُ بلا إله إلا الله إذا جاءتْ يوم القيامة؟!». أفلا يحقُّ لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لك أيها الشيخُ المعمَّرُ: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتْ يوم القيامة وأصحابُها الأصلُ فيهم أنهم مسلمون، معصومو الدَّم والمال والعرض، لكنك شاركت في سفك دمائهم، وهتك أعراضهم، وتدمير ديارهم؛ بخُطَب الفتنة والتَّحريض على الثورة والخروج إلى المظاهرات والاعتصامات ومواجهة العساكر والشُّرَط في بلاد الإسلام؟! بل دفعتْكَ حماستك وتهورك إلى التعظيم والإعجاب بحرق (محمد البوعزيزي) نفسه منتحرًا، وهو لم يفعل ذلك إلا بسبب الظلم والفقر، ساخطًا على قضاء الله وقدره، فكنت أول عالمٍ في تاريخ الأديان كلِّها؛ يستحسن هذه الفعلة الشنيعة ويحيِّي مرتكبها [على قناة (الجزيرة) مساء الأحد 16/1/2011]!
لقد كنتَ تعلمُ بوصية النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأمره ـ القطعيِّ الثبوت، القطعيِّ الدلالة ـ بالصبر على جور الحكام وظلمهم، والنهي عن الخروج عليهم، وعدم رفع السلاح على المجتمع المسلم، وكفِّ اللسان واليد في الفتن، وملازمة البيوت؛ فكنتَ أَولَى الناس ـ وقد أدركت حقيقة (القضية المصيرية الكبرى) ـ أن تدرك بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك إقرارًا للظلم، ولا وقوفًا في صف الظالمين، ولا تشجيعًا للمسلمين على الجبن والضعف وتضييع الحقوق؛ لكن أمر بذلك إشفاقًا عليهم، وحفظًا لديانتهم، وتنبيهًا لهم على الانشغال بالأولى والأهمِّ والأحقِّ، وهو الدار الآخرة، لأنها الغاية المقصودة، (أما الدُّنيا) ـ فكما قلتَ في كتابك 136 ـ: (هي عند المسلم أداةٌ لا هدفٌ، ووسيلةٌ لا غايةٌ). فالثورة والخروج والمغالبة على الدنيا مخالفٌ للمقصِد الأصليِّ من أحكام الشريعة؛ وهو الذي بيَّنتَه في قولكَ ـ فأصبتَ وأحسنتَ ـ: (في الإسلام تشريع ومعاملات، ولكن المقصود منها هو تنظيم حياة الناس حتى يستريحوا، ويبرؤوا من الصراع على المتاع الأدنى، ويفرغوا لمعرفة الله تعالى، وعبادته، والسعي في مرضاته).
لهذا وردَ الأمرُ النبويُّ ـ وهو صحيحٌ بشواهده وطرقه كما في (البدر المنير) لابن الملقن 9/8، و(إرواء الغليل) للألباني (2451) ـ أن يختار المسلمُ في الفتن واختلاف الناس واضطراب أحوالهم أن يكون: «عبدَ الله المقتول لا القاتل»، لأنه لو قُتِل مسلمًا مظلومًا سيربحُ آخرته وإن خسر دنياه. هذه الوصية خلاصة نبوية كافية للقضية التي أفردتَ لها كتابكَ هذا، فليتكَ أفردتَ فيه مبحثًا عن أحاديث الفتن والخروج والمغالبة على الدنيا، فإنها ليست أحكامًا دنيويةً مجردةً، بل من صُلب العقيدة الإسلامية وأصولها؛ من جهة أَنها تجعل قضية المسلم هي العمل لله تعالى لا لحظوظ النَّفس، وللآخرة لا للدُّنيا، وللحياة الأبدية الدائمة لا للحياة القصيرة الزائلة.
ألم تعلم أنَّ هذه الدار دارُ ابتلاء وامتحان، ومن المحال أن يتحقَّق فيها الخير المطلق، أو يقام فيها العدل المطلق، فالواجب على العاقل أن يعمل للدار التي فيها الخير المطلق والعدل المطلق والسعادة التي لا نهاية لها، وهذه هي العبودية والربانية التي بيَّنتَها في كتابك، وهي كما قلتَ 138: (إنَّ الربانيةَ قد تحرم الإنسانَ من بعض اللذائذ العاجلة، وبعض المنافع القريبة، ولكنها تحميه بهذا الحرمان من شرور ومخاطر كانت ستعود بالضرر المؤكد عليه، أو على مجتمعه، أو على الإنسانية). فحثُّك ـ أنتَ وأمثالك من الإسلاميين الحركيين ودعاة الفتنة ـ المسلمين على المغالبة على الدنيا، والصراع عليها، ومنازعة الحكام، وصياحك على منبر الجمعة: (ثوروا! اخرجوا!)؛ ما كان إلا طلبًا لــ: (بعض اللذائذ العاجلة، وبعض المنافع القريبة)؛ ثم كانت النتيجةُ فسادَ أحوال الناس في دينهم ودنياهم معًا، وهذه عقوبة عاجلة لكل من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف أوامره ووصاياه: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا * وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا * ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا} [النساء: 67-70].
نعم ـ أيها الشيخ القرضاويُّ ـ؛ قد ضيَّعتَ أمر الدِّين، وتسببتَ في فساد عظيم في دنيا المسلمين، وتأثر بخطابك ودعوتك الآلاف من طلبة العلم والدُّعاة والمثقفين ـ بله العامة ـ فصاروا لا همَّ لهم إلا السياسة والاقتصاد والتنمية والنهضة المادية؛ فلا أرى نصيحةً أختم بها هذه الكلمةَ أحسنَ من قولك 79: (فكِّر في نهايتك إن كنتَ ذا دينٍ: أمرُ الدِّين بالنسبة للإنسان ليس أمرًا هيِّنًا، بحيث يمكن السهو عنه، أو الانشغال بغيره، أو إرجاؤه إلى فرصة أخرى من العمر تأتي أو لا تأتي)، فعجِّل بتوبتك، وأعلنها على الملأ؛ لعل الله تعالى يتقبل منك، ويتجاوز عنك، إنه غفورٌ رحيم، له الحمد في الأولى والآخرة.
استدراك:
بعد كتابة هذا المقال اطلعتُ على تغريدة للقرضاوي على حسابه الموثَّق في (تويتر)، فإذا به يقول ـ بتاريخ: 22/10/2018 ـ: (عقيدةُ التَّوحيد في حقيقتها ما هي إلا ثورة لتحقيق الحرية والمساواة والأُخوَّة للبشر، حتى لا يتخذ بعض الناس بعضًا أربابًا من دون الله، وتبطل عبودية الإنسان للإنسان).
قلت: قد نقض القرضاويُّ بكلمته الأخيرة ـ هذه ـ كلَّ ما سطَّره في كتابه، وهكذا هو حاله في أكثر ما جرى به قلمه من الحقِّ في كتبه وفتاويه، ينقضه بقوله وعمله، فهو كما وصف ربُّنا سبحانه: {كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} [النحل: 92]، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم.
كتبه:
عبد الحق التركماني
الأربعاء 11 شوال 1438هـ الموافق 5 تمُّوز 2017م